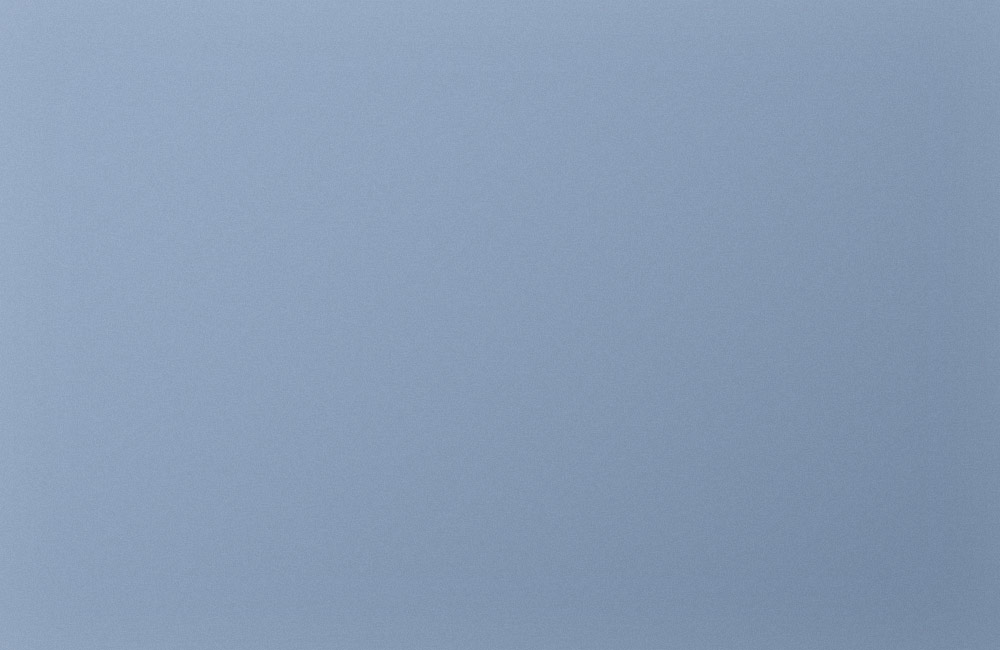من كتاب السرديِّات السمعية: دروس من دراما الراديو (2021)، تحرير لارس بيرنايرتس وغارميلا ميلدورف، جامعة ولاية أوهايو، ترجمة: بندر الحربي
 تُصنّف دراما الراديو بوصفها شكلاً سرديًا بالوسيط والنوع معًا إذا ما فُسّر اسمها حرفيًا. فالراديو بصفته وسيطًا يختلف عن النص المكتوب والمسرح والسينما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية. أما الدراما، فتختلف ضمن وسيط الراديو (أو بشكل أوسع ضمن وسائط الاتصال الصوتي عن بعد، بما في ذلك البودكاست عبر الإنترنت) عن الأخبار والبث الرياضي والبرامج الحوارية، والكتب الصوتية. وبالمثل، تختلف الدراما عن الروايات والصحافة وكتابة التاريخ ضمن الأنواع السرديِّة.
تُصنّف دراما الراديو بوصفها شكلاً سرديًا بالوسيط والنوع معًا إذا ما فُسّر اسمها حرفيًا. فالراديو بصفته وسيطًا يختلف عن النص المكتوب والمسرح والسينما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية. أما الدراما، فتختلف ضمن وسيط الراديو (أو بشكل أوسع ضمن وسائط الاتصال الصوتي عن بعد، بما في ذلك البودكاست عبر الإنترنت) عن الأخبار والبث الرياضي والبرامج الحوارية، والكتب الصوتية. وبالمثل، تختلف الدراما عن الروايات والصحافة وكتابة التاريخ ضمن الأنواع السرديِّة.
تستمد الدراما الإذاعية من وسيطها طبيعة سمعية بحتة تتجاوز حدود السرد الشفهي، إذ تستبعد عناصر دلالية مثل إيماءات الراوي وتعبيرات وجهه. وتكتسب الدراما الإذاعية من نوعها نمطًا سرديًا مُحاكيًا mimetic مهيمنًا.
وفي هذا النمط، تُعرض الحبكة مباشرة للمستمعين من خلال حوار الشخصيات، ومؤثرات عالم القصة الصوتية، فضلاً عن موسيقى عرضية لا تنتمي إلى هذا العالم السرديِّ، بديلًا لوساطة الراوي.
وعند الجمع بين هذه السمات الوسيطة والنوعية، يظهر شكل سردي قد يبدو ناقصًا على نحوٍ كبير. فالدراما الإذاعية تفتقر إلى المعلومات البصرية المتوفرة في دراما المسرح أو السينما. وفي كثير من الحالات تفتقر إلى مزايا الراوي الذي يسهل النشاط المعرفي للجمهور بتحديد الحوار لشخصيات معينة، ووصف الأجواء، أو الإشارة إلى الحركات.
في النمط المُحاكي المحض، تُلمح جميع تفاصيل الحبكة عبر ما يمكن تسجيله ميكانيكيًا بجهاز صوتي، مستثنى من ذلك الموسيقى الخارجة عن السرد. فالشخصيات لا تُفرّق بمظهرها، بل بنبرات أصواتها، مما قد يصعّب التمييز بينها على بعض المستمعين.
فضلًا عن ذلك، وبوصفها وسيطًا متدفقًا، تتكشف دراما الراديو بوتيرتها الفريدة، ولا تتيح للمستخدمين التحكم في تدفق المعلومات (أو لم تفعل ذلك حتى ظهر اليوتيوب). هذا يختلف عن السرد المكتوب حيث يمكن للمستخدمين تسريع القراءة أو إبطاءها، أو إعادة قراءة المقاطع، أو العودة بضع صفحات للتحقق من التفاصيل التي ربما فاتتهم.
تفسر هذه القيود سبب التناقص الكبير في شعبية دراما الراديو منذ ظهور التلفزيون، الذي يعد مزودًا رئيسيًا آخر للترفيه المنزلي. فبينما يُنظر إلى دراما التلفزيون وسيطًا ساخنًا
وفقًا لماكلوهان، فإن دراما الراديو تُعد من بين أبرد
الوسائط السرديِّة. فهنا، كل ما ليس صوتًا يُترك للخيال. أما الصوت فيتطلب تفسيرًا لتحديد سببه ومصدره في فضاء عالم القصة وكيفية ارتباطه بالفعل السرديِّ. فلا يحمل أي مؤثر صوتي تفسيرًا ذاتيًا.
ومع ذلك، سيكون من الخطأ قصر دراما الراديو على النمط المُحاكي، وذلك لسببين. أولاً، دراما الراديو ليست مجرد محاكاة أو تسجيل صوتي زائف لدراما المسرح؛ فهي أكثر تنوعًا بكثير مما يوحي اسمها، وتسميتها مضللة. وثانيًا، مثلما يمكن للعناصر السرديِّة أن تشق طريقها إلى دراما المسرح عبر معلّق في المسرح الملحمي، أو من خلال الجوقة في التراجيديا اليونانية، وإلى الفيلم عبر السرد الصوتي، فإنها تستطيع أيضًا التسلل إلى دراما الراديو من خلال الأجزاء المروية. على العكس من ذلك، يمكن النظر إلى حوار السرد القصصي لحظات محاكية، على الرغم من أن صيغ العزو قال
وقالت
تشير إلى وجود راوٍ يقتبس.
يُبرز التفاعل بين السرد القصصي والمُحاكي في دراما الراديو بوضوح في مسرحية الفنان أورسون ويلز الإذاعية حرب العوالم
. وثمة من زعم أن هذا البث تسبب في ذعر جماهيري بسبب غزو المريخ للولايات المتحدة. (في الوقت الحاضر، يُشتبه في أن هذا الذعر كان أخبارًا مزيفة، أو على الأقل مبالغًا فيها بشكل كبير من الصحافة المكتوبة بهدف تشويه سمعة الراديو، منافسها في مجال الأخبار). وقُدم البث ضمن سلسلة دراما إذاعية، مما يجعل من الصعب تصديق أن بعض الناس قد أخذوه على محمل الجد، ومع ذلك، يبقى احتمال أن بعض المستمعين انضموا متأخرين إلى البث بعد تحويل قنواتهم.
تبدأ المسرحية بسرد حكائي يعلن فيه أورسون ويلز، متحدثًا باسمه، أن كوكب الأرض كان تحت مراقبة كائنات فضائية منذ بداية القرن العشرين، وأن ذلك أدى إلى الأحداث الدرامية في 30 أكتوبر 1939. (وليس من قبيل المصادفة، هذا هو اليوم الفعلي للبث، مما يشكل دليلاً على حالته الخيالية). لا يكذب أورسون ويلز، لأن البث مؤطر بوصفه دراما، بل يستغل الإمكانية الكامنة في الخيال لانتحال شخصية نظيرة له في عالم بديل.
يتبع هذا المدخل السرديِّ محاكاة تمثيلية لبث إذاعي تتقاطع فيه البرامج الموسيقية مرارًا بـ أخبار عاجلة
. هذه الأخبار تعلن عن وصول سفن الفضاء إلى نيو جيرسي، وهبوط المريخيين، وقتل الشهود، وهزيمة القوات العسكرية المرسلة لمكافحة الغزاة، وزحفهم نحو مدينة نيويورك، وفرار المواطنين. ورغم أن هذا البث الزائف مليء بأعمال السرد من صحفيين أُرسلوا إلى موقع الهبوط، إلا أنه يجب اعتبارها عرضًا محاكيًا؛ لأن هذه التقارير تصف أحداثًا تحدث هنا والآن، في محاكاة لعمل يجري في الوقت الفعلي.
في الدقيقة 39:00 من البث، يُعاد التأكيد على أنَّ البث دراما إذاعية. بحيث لو تسبب في ذعر جماهيري، لكان الجمهور قد تلقى الرسالة في فترة زمنية قصيرة، ولكانوا غافلين عن التناقضات الزمنية. إذ كيف يمكن لصحفي أرسله الاستوديو من نيويورك إلى غروفرز ميل، نيو جيرسي، لتغطية الحدث أن يصل إلى هدفه في غضون بضع دقائق؟ وكيف يقدر سكان نيويورك أن يفروا خلال الساعتين الماضيتين، بينما استمر البث المزعوم في الوقت الفعلي أقل من ثلاثين دقيقة عندما قُدمت هذه المعلومات؟ بل كيف باستطاعة الجيش الأمريكي أن يشن هجومًا في مثل هذا الوقت القصير؟ بعد الاعتراف بالخيالية، ينتهي الإنتاج بسرد قصصي رجعي من صحفي إذاعي يعتقد أنه الناجي البشري الوحيد من الكارثة، حتى يلتقي بناجٍ آخر.
تثير هذه الطبقات السرديِّة المتعددة مشكلة الوساطة السرديِّة. فالبث المُحاكي يخضع لسيطرة أورسون ويلز الخيالي، وداخل البث تُضبط تقارير الصحفيين الميدانيين من المذيعين في الاستوديو. عندما يُدمّر استوديو التسجيل (في الدقيقة المشؤومة 39) ويحل محله السرد الرجعي للناجي، ينكسر إطار البث المباشر، وتنتهي القصة. بيد أنَّ الوساطة لا تحدث فقط بين الطبقات السرديِّة لعالم القصة، بل تربط أيضًا القصة ككل بالمستمع في العالم الحقيقي. إذا كانت الوساطة، كما يعرفها لارس بيرنايرتس، تمثل الطريقة التي تُقدم بها القصص للجمهور
، أو بتعبير أدق، نسبة المصدر إلى الترتيب السرديِّ للمؤشرات
، فكيف يمكن لمفهوم الوساطة أن يميز بين العرض السرديِّ والمُحاكي؟
ترددت السرديِّات لفترة طويلة في قبول العرض المُحاكي بوصفه شكلًا من أشكال السرد. على الرغم من أن بعض الآباء المؤسسين للسرديات مثل رولان بارت وكلود بريموند على وجه الخصوص، رأوا السرد ظاهرة تتجاوز الوسائط والأنواع، إلا أن تأثير العمل الرائد لجيرار جينيت أدى إلى تركيز السرديِّات على الأشكال الأدبية المكتوبة، وإلى استبعاد صامت إلى حد ما للنصوص الدرامية والغنائية.
يكمن السبب وراء هذا الاستبعاد في الادعاء المثير للجدل بأن السرد يحتاج إلى راوٍ، نظرًا لأن شخصًا ما ينبغي أن يكون مسؤولاً عن فعل سرد القصة. لكن لا يوجد راوٍ في الغالبية العظمى من النصوص الدرامية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سرديات.
يُعزى التوسع في مرحلة ما بعد الكلاسيكية في السرديِّات إلى الاعتراف بأنه إذا كانت السرديِّة
تكمن في قدرة النص على استحضار قصة في ذهن المتلقي (مهما كان تعريف القصة
)، فإن هذه القدرة يمكن العثور عليها في النصوص السرديِّة والأدائية على حد سواء. غير أنَّ توسع السرديِّات إلى النمط المُحاكي، والذي مكنها من المطالبة بوسائط أخرى غير اللغة المكتوبة والشفوية، خلق المشكلة التي تشكل محور مساهمة لارس بيرنايرتس: مشكلة تعريف الوساطة السرديِّة.
في حين يتدخل الرواة بين المتلقي والأحداث المروية، والتي يعتبرها المتلقي مؤكدة من قبل الراوي (على الرغم من أن المؤلف هو من يقوم بتكوين السرد)، يخلق العرض المُحاكي وهم الفورية
(لاقتباس من بيرنايرتس) من خلال دعوة الجماهير لتخيل أنهم يشاهدون تطور الفعل السرديِّ على نحوٍ مباشر.
ومع ذلك، يظل الجمهور مدركًا أنهم لا يشاهدون الحياة نفسها، بل تمثيلاً، مما يعني أن المعلومات السرديِّة لا تحدث تلقائيًا، بل هي نتاج فعل متعمد من التواصل السرديِّ. فكيف يمكن تعريف هذا الفعل؟ أحد الاحتمالات هو استعادة التناظر بين السرد القصصي والمُحاكي من خلال افتراض وجود شخصية راوٍ في الحالة المُحاكية؛ فعلى الرغم من أنها لا تُرى أبدًا على خشبة المسرح، أو على الشاشة، أو في الإعدادات الخيالية للدراما الإذاعية، فإن هذه الشخصية الشبحية ستكون الوسيط الذي يوصل النص إلى الجمهور والذي يتحمل مسؤولية شكله السرديِّ.